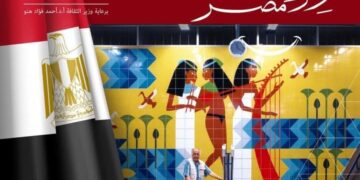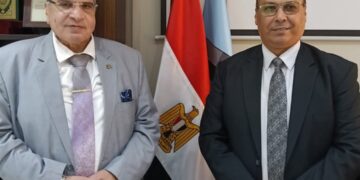ناصر السلاموني “البُهرة: ما لهم وما عليهم”
كنت قد تناولت في مقالين سابقين طائفة الدروز، وعلاقتهم المعقدة بإسرائيل، خاصة في سوريا، وتطرقت إلى نشأتهم في مصر إبان حكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، وما حملته دعوتهم من مخالفة لكثير من أصول الدين، وانخراطهم في السياسة، ومحاولات إسرائيل استغلالهم كأقلية. واليوم نتناول طائفة أخرى نشأت أيضًا في مصر الفاطمية، ثم انتقلت إلى اليمن واستقر بها المقام في الهند، ألا وهي طائفة البُهرة ذات الاسم المأخوذ من التجارة.
في قلب القاهرة القديمة، حيث تتنفس الجدران عبق الفاطميين وتاريخهم، تتمدد الأزقة في صمت كأنها تحفظ سرًّا عتيقًا، لاحظ الأهالي في نهايات القرن الماضي رجالًا بلباس أبيض ناصع، وعمائم محكمة، ذوى هيئة توحي بالوقار والنظام. يدخلون الأسواق، يشترون العقارات بمبالغ ضخمة، يرمّمون المساجد، ويوزّعون الهدايا ثم يغادرون بهدوء. وعندما يُسأل عنهم، يأتي الجواب بأنهم “البُهرة“، تلك الطائفة الغامضة التي تسللت بهدوء إلى وعي الشارع، لكنها لم تخرج بعد من دائرة التساؤل والحذر.فإذا نظرنا أعلى قمة جبل المقطم في القاهرة نرى مسجد “اللؤلؤة” وعندما تسأل عنه يقال لك إنه مزار شيعي لطائفة البُهرة الإسماعيلية الذين يفدون إليه من مصر ودول عدة أبرزها الهند واليمن وإيران، ويتخذونه مكانًا للعبادة والتبرك، خاصة يوم الجمعة. يعود بناء المسجد إلى عام 406هـ في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي، وسُمي باللؤلؤة نسبة إلى قبة كانت تضيء ليلاً فتشبه اللؤلؤ وسط الجبل، وقد رممته طائفة البُهرة عام 1989 بعد إذن من الرئيس السادات ضمن مساعٍ لوحدة العالم الإسلامي. المسجد يتخذ هيئة مستطيلة شاهقة تشبه مبنى سكنيًا، وله مدخل خاص بين المقابر يُمنع دخوله إلا بتصريح أمني، وتعيّن له الطائفة حارسًا خاصًا براتب شهري، مما جعله مكانًا معزولًا عن سكان المنطقة الذين يبدون تحفظهم على نشاطه السري. وتؤكد وزارة الأوقاف أن المسجد تابع لها ويخضع لإشرافها، مع تشديد الرقابة لمنع أي محاولة لنشر المذهب الشيعي بين الأهالي.
والآن بعد الذى عرفناه من خلال الشارع والأثر نتجه بعقولنا نحو التاريخ لنعرف أكثر عن هذه الطائفة فنجد أنها تنتمي إلى الإسماعيلية الشيعية، وتُعدّ فرعًا من فروع الدعوة الفاطمية التي رأت في (إسماعيل بن جعفر الصادق) الإمام الشرعي دون منازع. ومع زوال الدولة الفاطمية، اختفى (الإمام الطيب بن الآمر بأحكام الله)، فاعتبره أتباعه “الإمام المستور”، وبدأ عهد “الدعاة المطلقين” الذين تولّوا قيادة الطائفة نيابة عن الإمام الغائب. من مصر انتقلت الدعوة إلى اليمن، ثم إلى الهند، حيث نمت وازدهرت.
وفي القرن السادس عشر الميلادي، انقسمت الطائفة إلى ثلاث فرق: الداودية، والسليمانية، والعلوية. وتُعدّ الفرقة الداودية الأكبر والأكثر تأثيرًا، ومقر قيادتها العليا اليوم في مدينة مومباي بالهند، حيث يتزعمها “مفضل سيف الدين” بلقب “سلطان البُهرة”. وللطائفة نظام داخلي دقيق يشبه كيان دولة مصغرة، يضم وزراء ووكلاء وقضاة وإداريين، يتولّون تنظيم شؤون أفراد الطائفة في أكثر من أربعين بلدًا، من بينها مصر.
تُعرف عقيدة البُهرة بطابعها الباطني الغامض؛ إذ يعتقدون أن النصوص الدينية تحمل معاني باطنية لا يدركها إلا الأئمة والدعاة، ويوقّرون أئمتهم بدرجة قد تصل إلى العصمة، بل ويرفع بعضهم من مقام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فوق مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كما يُجلّون الخلفاء الفاطميين، خاصة الحاكم بأمر الله، إلى درجة أقرب للتقديس. وتختلف بعض شعائرهم عن جمهور المسلمين، منها الصلاة دون أذان، والتوجّه في بعض طقوسهم نحو القاهرة بدلًا من الكعبة، كما تُؤدى بعض العبادات بلغات غير عربية كالفرسية أو الجوجاراتية. ويُلزم أتباعهم بدفع ضريبة الخُمس، التي تُشكّل موردًا ماليًا أساسيًا يُدار من قبل الداعي المطلق.
أما في مصر، فقد بدأ وجود البُهرة يظهر بشكل خافت أوائل القرن العشرين، ثم تعزز تدريجيًا مع ترميمهم لعدد من المساجد الأثرية كجامع الحاكم بأمر الله وجامع الأقمر، وسط تمويلات سخية ونشاطات اتسمت بالكتمان. واستمرّ نفوذهم في الاتساع بهدوء، عبر شراء العقارات، والمشاركة في مشروعات تراثية وتجارية، وزيارات متكررة من قياداتهم الدينية. وقد أثار هذا الحضور المتنامي نقاشًا دينيًا وثقافيًا بين من رأى فيه نوعًا من الانفتاح والتعدد، وبين من تخوّف من تغلغل طائفة تحمل معتقدات باطنية في قلب المجتمع المصري.
اقتصاديًا، تحظى الطائفة بنفوذ متنامٍ، بفضل التزام أفرادها بدفع الخُمس، واستثماراتهم الواسعة في الذهب والعقارات والمطاعم، إضافة إلى شبكة تجارية محكمة تنتشر داخل مصر وخارجها، غالبًا تحت مسميات لا تشير مباشرة إلى اسم الطائفة، ما يمنحهم هامشًا كبيرًا من الحرية والخصوصية في التحرك.
رأي أهل السنة والجماعة في التعامل والزواج
ينظر جمهور أهل السُّنَّة والجماعة إلى طائفة البُهرة بعين التحفُّظ، بسبب ما يُنسب إليهم من تأويلات باطنية تُخرج بعض معتقداتهم عن إطار العقيدة الإسلامية الصحيحة. وقد عبّر علماء معتبرون عن رفضهم لما تحتويه كتبهم من غلو في الأئمة، وإنكار لبعض الثوابت العقدية كالبعث الجسماني، وهو ما جعل التعامل معهم، خاصة في الأمور العقدية، محل حذر شرعي.
أما في مسألة الزواج منهم، فقد ذهب عدد من العلماء إلى عدم جواز زواج المسلم السني من البُهرية، لما في ذلك من مفاسد عقدية وتربوية، خصوصًا إذا نشأ الأبناء على معتقدات الطائفة. ويرى بعض الفقهاء أن الزواج من أصحاب العقائد الباطنية يدخل في دائرة المحظور شرعًا، إذا ثبتت مخالفتهم لأصول الدين.
في المقابل، يُجيز فقهاء آخرون التعامل معهم في المعاملات الدنيوية بالضوابط الشرعية، ما لم يظهر ضرر أو يُخشَ التأثر بمعتقداتهم، مع التأكيد على أهمية التبيين والدعوة بالحكمة لمن كان منهم من عوام الطائفة، لا يعلم تفاصيل ما وُرث من عقائد.
ومع ذلك، فإن من تعامل معهم يذكر حرصهم على النظام، وحسن السلوك، ونظافة الملبس والمأكل. لكن يبقى السؤال مفتوحًا: هل يمكن الفصل بين السلوك الظاهري والمعتقد الباطني؟ وهل التسامح مع الأقليات يجب أن يشمل أيضًا قبول أفكار تخالف ثوابت الإسلام؟ أم أن الانفتاح يجب أن يكون مشروطًا بالوضوح والشفافية؟
لا شك أن طائفة البُهرة نجحت في البقاء بعيدة عن الصراعات السياسية والدينية الكبرى، لكنها في نظر عدد من العلماء والمفكرين ما تزال تمثل تيارًا باطنيًا غامضًا، يجمع بين الانغلاق والطاعة المطلقة للداعي، ويستتر بثوب العمارة والتراث والثروةمما يسبب الحذر من التعامل معهم.
وهكذا، يبقى البُهرة لغزًا يتجدّد، بين ظاهرٍ مزخرف وباطنٍ مسكوت عنه، وتبقى القاهرة، بكل ما تحمله من التاريخ، شاهدًا حيًّا على التعايش، والتعدد، ومحاولات مستمرة لفهم ما وراء الظاهر. لأن شعبها من أذكى الشعوب وأكثر الشعوب احتواء للفرقاء ودمجهم في جعبتها.